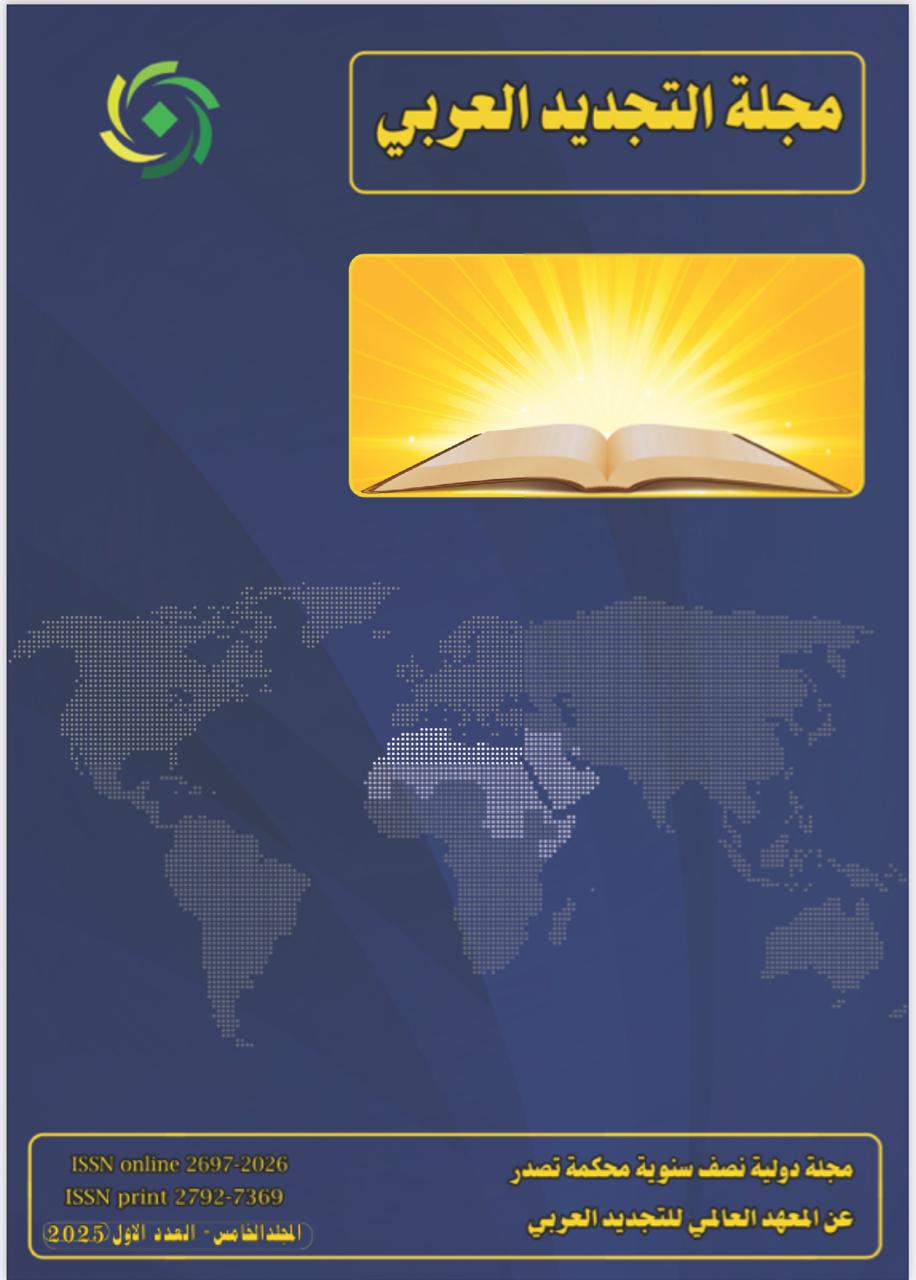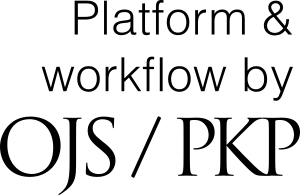ما بين السّلطنة والكيان، أزمة هويّة ومواطنة (لبنان انموذجًا)
الملخص
شهد الربع الأول من القرن العشرين نهاية السّلطنة العثمانية في المشرق العربي وظهور مصطلح "الدولة" بمفهوم الايديولوجية القومية أو من خلال التقسيمات الجغرافية ضمن اتفاقات سرية، سيطرت من خلالها الدول الغربية الاستعمارية (الكولونية) على تقاسم إرث السّلطنة.
وكانت قد استطاعت السّلطنة ان توجد عامل الاستقرار السياسي أقله في المشرق العربي حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر وبعدها ازداد ضعفها وكثرت الامتيازات الاجنبية وتدخلات الدول الأوروبية وتمرد الولاة والأمراء... وفي نفس الوقت بدأت ارهاصات القومية والهويّة تدخل إلى عمق التفكير العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين متزامنةً مع بداية التدخل الاجنبي الأوروبي وظهور مفهوم حماية الطوائف وخاصة المسيحية كدليل على الضعف الذي أصاب السّلطنة.
وأكثر ما يلفت نظر المؤرخين هو ان الهويّة الوطنية والقومية العربية والمواطنة ظهرت ضمن القيود الطائفية، حتى الجغرافيا والديمغرافية المتداخلة لم تثنِ أصحاب الكيان الجديد وتقسيمات الغرب الاستعمارية (اتفاقية سايكس- بيكو) منذ بداية العام 1920 من اداء سياسي دون مستوى فكرة الدولة الجامعة منذ أكثر من مئة عام وحتى وقتنا الحالي.
هذه المسيرة من التحولات السّياسية لم تحسم الجدل بين اللبنانيين حول الهويّة والانتماء، وان كان الدستور قد حسمها بان لبنان عربي الهويّة ووطن نهائي وكرس وحدة الشعب والارض والمؤسسات والنظام الديمقراطي، ولكن هناك أزمة في التطبيق والممارسة وتحديات الطوائف ومكوناتها الحزبية المختلفة ضمن الايديولوجيات الطائفية والمناطقية والقومية والصراعات الفكرية وبين من ينادي بالكونفدرالية أو الفدرالية واللامركزية والحياد ووجود بنود في الدستور ما زالت تعزز الطائفية تطبيقًا وممارسًة منذ العام 1926... وينبري المنظّرون الطائفيون في تفصيل المزاج الشعبي والطائفي، ويزيد الأمور سوءًا وجود عدد كبير من المؤرخين والباحثين والمثقفين ورجال الدين والاحزاب الذين يعملون على تزكية الخلافات وإضعاف الشعور بالهويّة الوطنية والمواطنة وعمق الانتماء القومي من خلال الإرث الثقيل الذي بقي منذ أواخر الدولة العثمانية وتم تعزيزه وترسيخه من خلال الدور الفرنسي بمفهوم الانتداب.